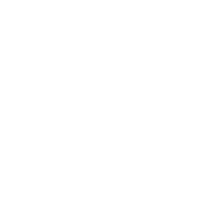المرأة في مواجهة المستحيل: الرمزية وثقل الانتظار

المؤلفون:
المؤلفة: د.مريم الدوسري، رويال هولواي، جامعة لندن.
سارة شودري، بيركبيك، جامعة لندن، المملكة المتحدة
آهو تاتلي، جامعة كوين ماري في لندن، المملكة المتحدة
كاثرين سييرستاد، جامعة جنوب شرق النرويج
نشرت هذه الورقة في أكتوبر 2021
الخلاصة
من خلال توسيع أفق نظرية الرمزية وأعمال كانتر المتعلقة بالتمثيل العددي داخل المؤسسات، نسلّط الضوء على الدور المحوري للسياق المجتمعي في إنتاج واستدامة التفاوت بين الجنسين، لفهم التجارب المعاشة للنساء الرمزيات في بيئات العمل.
تعتمد هذه الدراسة على تحليل 29 مقابلة متعمقة أُجريت في شركة متعددة الجنسيات تعمل ضمن بيئة اجتماعية ومؤسسية ذات خصوصية في السعودية. ومن خلالها، تطوّر الورقة تصنيف كانتر للأدوار الرمزية، بما يسمح بفهم أعمق لكيفية تجذر التمثيل الرمزي ضمن السياق المحلي.
وتستكشف الدراسة على نحو خاص التفاعل المعقّد بين شركة ذات طابع غربي تتبنى قيَمًا ومعايير ليبرالية، وبين السياق الاجتماعي الأبوي والتقليدي السائد في المملكة. ومن خلال هذا التفاعل، تكشف النتائج أن السياق التنظيمي ليس محايدًا بطبيعته، بل يتقاطع حتميًّا مع السياق المجتمعي، مولّدًا أشكالًا فريدة من الرمزية المؤسسية التي لا يمكن فصلها عن البيئة الاجتماعية الأوسع.
مقدمة
رغم التقدّم الحاصل في بعض دول العالم، لا يزال تمثيل المرأة في المناصب الإدارية والقيادية يعاني من التفاوت بشكل لافت. ففي عام 2018، شغلت النساء 39% من المناصب العليا في الولايات المتحدة، و22% في المملكة المتحدة، و20% في الهند. أما في السعودية، فقد بلغت هذه النسبة 7% فقط، حيث تستمر العلاقات بين الجنسين، والعمل، والنسيج الاجتماعي في التشكّل ضمن بنى أبوية تقليدية، إلى جانب قوانين صارمة للفصل بين الجنسين.
ومؤخرًا، أعلنت الدولة عن هدف استراتيجي يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، لا سيما في مواقع القيادة، بحلول عام 2030. ورغم ما تحمله هذه المبادرات من وعود بالتغيير، إلا أنها غالبًا ما تُنتقد على اعتبارها خطوات رمزية، في ظل بقاء المرأة السعودية محكومة بأنظمة قانونية وثقافية واجتماعية ذات طابع ذكوري، تحد من إمكاناتها المهنية وتقيّد مشاركتها الفعلية.
تتناول هذه الورقة البحثية الكيفية التي تتفاوض بها النساء "الرمزيات" العاملات في شركة سعودية كبرى متعددة الجنسيات مع منظومة من السياسات والمعايير التنظيمية المستلهمة من الثقافة الغربية، التي تدّعي المساواة، بينما هنّ يعملن ضمن سياق اجتماعي أبوي لا يزال راسخًا.
من هذا المنطلق، يُعدّ مفهوم "الرمزية" كما طرحته روزابيث موس كانتر مدخلًا ملائمًا لفهم التحديات التي تواجهها النساء القليلات العدد في أماكن العمل، مثل: ضغوط الأداء العالية، والشعور بالعزلة، والوقوع في أدوار نمطية محدودة. إلا أن هذه الدراسة لا تكتفي بتطبيق النظرية في إطارها التقليدي، بل تتجاوز ذلك لتسلّط الضوء على أشكال جديدة من الرمزية متجذرة في السياق المحلي، وتكشف كيف تتقاطع أحيانًا - بل تتصادم - القيم التنظيمية التي تروّج للمساواة وتخصيص حصص للنساء، مع الضغوط المجتمعية التي ما زالت متأثرة بعدم التوازن الجندري والهياكل الأبوية.
وتعتمد الورقة على نظرية كانتر كإطار مفاهيمي، لكنها تُوسّع نطاق التحليل من داخل المنظمة إلى التفاعل المستمر بين العوامل الفردية والتنظيمية والمجتمعية، والتي تخلق أشكالًا دقيقة ومتنوعة من الرمزية. ومن خلال دراسة حالة في السعودية، تسعى الورقة إلى فهم طبيعة الرمزية التي تعيشها النساء السعوديات، وكيف يتفاعلن مع هذه الوضعية في ظل مساحة محدودة من الحرية الفردية، داخل بيئات تتداخل فيها السياقات التنظيمية مع القيم المجتمعية.
وتقدّم هذه الدراسة رؤى جديدة من واقع لم يُتناول كثيرًا في الأدبيات، ما يُغني الفهم العام لآليات التمييز الجندري في العمل. كما تتجاوز مساهمتها الجانب التطبيقي، لتقترح قراءة جديدة لنظرية كانتر، تبرز إمكانيات توظيفها بطريقة أكثر تفاعلية، لا تقتصر على داخل المؤسسة، بل تنظر أيضًا إلى تأثير المجتمع باعتباره متغيرًا حيويًا، لا مجرد خلفية ثابتة.
يبدأ القسم التالي باستعراض موجز لنظرية كانتر حول "الرمزية" باعتبارها إطارًا مفيدًا لفهم تجارب النساء ناقصات التمثيل، مع الإشارة إلى أبرز الانتقادات النظرية التي وُجّهت لها، وبيان كيف تحاول هذه الورقة ملء الفراغات التي لم تُعالَج في الأدبيات السابقة. ثم تنتقل إلى عرض السياق السعودي فيما يخص سياسات توظيف النساء، يليه شرح للمنهجية البحثية.
أما النتائج، فتُقسَّم إلى قسمين: يتناول القسم الأول تجربة النساء الرمزية وكيف يتفاعلن مع التوترات بين التطلعات التنظيمية والمجتمع التقليدي، ما يكشف عن تعقيدات خاصة بهذا السياق. في حين يركّز القسم الثاني على مظاهر الانحصار في أدوار تقليدية داخل بيئة العمل السعودية. وتُختتم الورقة بمناقشة تسلط الضوء على أبرز إسهامات البحث، وتقترح توجهات مستقبلية لتعميق دراسة الرمزية الجندرية في السياقات غير الغربية.
المرأة الممثلة تمثيلًا ناقصًا في العمل: نظرية الرمزية
تستكشف نظرية الرمزية كيفية ترجمة التمثيل العددي إلى مزايا ومساوئ لمجموعات الأغلبية والأقلية، مما يخلق ثلاثة تحديات إدراكية رئيسية. أولًا، يواجه أعضاء مجموعة الأقلية (الرموز) بروزًا متزايدًا يؤدي إلى "تفرد" متصور وزيادة ضغوط الأداء. على سبيل المثال، تُظهر دراسة غاردينر وتيغمان التي أجراها غاردينر وتيغمان على صناعة يهيمن عليها الذكور أن النساء يعانين من مستويات أعلى من التوتر والتدقيق وضغوط الأداء مقارنة بزملائهن الذكور. ثانيًا، قد يعزل أعضاء الأغلبية/المجموعة المهيمنة (المهيمنون) الأقلية من خلال التأكيد على الاختلافات وإبقاء "الرمز الرمزي خارجًا قليلًا"، من خلال نشر النكات والمقاطعات و"اختبارات الولاء" والحد من وصول الرموز إلى المعلومات واستبعادهم من الشبكات المهنية غير الرسمية وآليات الدعم الجماعي. ينطوي التحدي الإدراكي الثالث على المعتقدات النمطية للمهيمنين التي تغذي تشويه الخصائص الاجتماعية للرموز.
ويتيح هذا التحدي الإدراكي الثالث بدوره وضع النساء الرمزيات في "فخاخ الأدوار" التي تحددها مجموعة الأغلبية. وقد حددت دراسة كانتر الأساسية أربعة أفخاخ أدوار رئيسية: (1) "الأم" - مع التأكيد على دور المرأة المنسوب إليها اجتماعيًا كمقدمة رعاية متعاطفة والافتراض الضمني بأن المرأة متاحة لتوفير الراحة والدعم العاطفي للرجل؛ (2) "المغوية" - مع التأكيد على جنسانيتها ورغباتها كما تحددها نظرة الرجل حيث تقوم المرأة بسلوكيات "أنثوية" بشكل ملحوظ، وعادة ما يتبنى ذكر في موقع قوة داخل المنظمة دور "حاميها"; (3) "حيوان أليف" - يرمز إلى موقف المرأة التابع من حيث الكفاءة التقنية/المهنية بحيث يُنظر إلى المرأة على أنها لطيفة ومسلية وفكاهية ولكنها في النهاية غير كفء في نظر زملائها الذكور ؛ و(4) "المرأة الحديدية" - ترمز إلى الأنثى العدوانية غير المطابقة للمواصفات التي يُنظر إليها على أنها قوية وكفء وانتهازية وتقاوم بنشاط فخ الأدوار الأخرى، وعادة ما يتم انتقادها لإظهارها سمات شخصية ذكورية وعدم كونها "أنثوية بما فيه الكفاية". يُعرّف فخ الأدوار النساء في المقام الأول من حيث علاقتهن بزملائهن الذكور ويقدم تصنيفًا مكثفًا للنساء يمكن للرجال فهمه والاستجابة له؛ مما يقلل من مستوى القوة التي تتمتع بها الرموز سواء في العمل أو على المستوى الفردي. ومع ذلك، فقد أبرزت الأبحاث أنه عادةً ما يكون من الأسهل على النساء الرمزيات الامتثال لهذه الأدوار أكثر من مقاومة توقعات الرجال. على سبيل المثال، تسلط دراسة ويتوك عن النساء العاملات في المهن اليدوية التي يهيمن عليها الذكور مثل البناء، الضوء على أن النساء غالبًا ما يقبلن تنميط الأدوار من أجل التقدم في حياتهن المهنية وقبول زملائهن الذكور.
لقد ولّدت نظرية كانتر عن الرمزية مجموعة مؤثرة من الأعمال التي تدرس تجربة النساء الرمزية عبر مجموعة من السياقات المهنية والتنظيمية مثل النساء العاملات في شركات المحاماة النخبوية؛ أو اللواتي يشغلن مناصب تنفيذية؛ أو اللواتي يعملن كمديرات، أو كمديرات، أو كرجال إطفاء. ومع ذلك، فإن الكثير من الأبحاث الموجودة، في محاكاة لعمل كانتر الأصلي، تركز على التفاعل بين المنظمة والفردإن هذا التركيز المفرط على المستوى التنظيمي للتحليل يقلل من شأن "الطبيعة الطارئة للرمزية"، وبالتالي فإننا لا نعرف سوى القليل جدًا عن أصول الأدوار والقوالب النمطية والتوقعات ومدى اندماج التفاعلات على المستوى الفردي والسياسات التنظيمية في نهاية المطاف في السياق المجتمعي الأوسع.
تستكشف بعض الدراسات كيف أن التجارب السلبية للنساء الرمزيات، وتحديدًا المشاكل المرتبطة بالظهور والتباين والاستيعاب، هي نتيجة لإعادة إنتاج المعايير المجتمعية داخل المنظمات. ومع ذلك، تسلط المراجعات الأخيرة لكل من هولجرسون وروماني وواتكينز وآخرون الضوء على أن المعايير المجتمعية والثقافية لا تزال غير مدروسة بشكل كافٍ في أدبيات الرمزية الحالية. ولذلك، فإننا في هذه المقالة نتجاوز في هذه المقالة المنظمة ونستكشف التوترات المرتبطة بالوضع الرمزي التي تتأثر بالتفاعل بين السياقات التنظيمية والمجتمعية. هذا الاعتبار الصريح للسياق المجتمعي مهم لأن المعتقدات الثقافية والهياكل المجتمعية تخلق تسلسلًا هرميًا من "الخصائص الاسمية" (على سبيل المثال، الجنس والعرق والدين) مع مستويات مختلفة من المكانة الثقافية و"قيم المكانة" المرتبطة بكل خاصية. ويؤثر التسلسل الهرمي المجتمعي للخصائص الاسمية على التفاعلات داخل المنظمات وبين الأفراد، والتي تساعد مثل "تموجات في بحيرة" في الحفاظ على الظروف الهيكلية التي أوجدت التسلسل الهرمي في المقام الأول. هذه الدائرية المتأصلة للتفاعل بين المستويات المجتمعية والتنظيمية والفردية تسلط الضوء على أهمية استكشاف كيفية تأثير السرد المجتمعي للنوع الاجتماعي على التوقعات التنظيمية والسلوكيات والتجارب على المستوى الفردي للمهيمنين والمهيمنات.
علاوة على ذلك، سبق أن انتُقد عمل كانتر لكونه محايدًا من حيث النوع الاجتماعي حيث تتوقع أن يكون للرجال تجارب مماثلة إذا كانوا أقلية تنظيمية. وترى "سياسة التفاؤل" هذه أن آثار الاختلافات بين الجنسين عرضية وقابلة للإصلاح، وبدلًا من ذلك تؤكد على أوجه التشابه بين الرجال والنساء.
وبذلك، فهي تقلل من أهمية الكيفية التي ترتكز فيها مصائد الأدوار والقوالب النمطية وتوقعات المهيمنين من المهيمنات على الهيمنة الذكورية، وعلاقات القوة غير المتكافئة بين المركز الذكوري المهيمن والهوامش الأنثوية. وقد سلطت الأبحاث السابقة الضوء على الاختلافات في تجارب الذكور والإناث الرمزية من حيث نمو الأجور والنتائج المهنية وقياس الأداء. يعاني الرجال الرموز في المهن التي تهيمن عليها الإناث من آثار سلبية قليلة جدًا بسبب وضعهم كأقلية "لأن الرجال يتمتعون بمكانة أعلى من النساء بسبب جنسهم ومكانتهم في المجتمع".
لذلك، فإن الفجوة البحثية الرئيسية التي يجب استكشافها هي كيف تتجلى المكانة الرمزية عندما تكون المجموعة ناقصة التمثيل عدديًا ورمزيًا. يهدف بحثنا إلى تسليط الضوء على هذا البعد الرمزي للتمثيل الناقص الذي لا يصبح مرئيًا إلا عندما يتم أخذ السياق المجتمعي في الحسبان.
على نحو متصل وأخيرًا، وفي ظلّ الخلفية المجتمعية للامتيازات الذكورية، يمكن للمهيمنين في مكان العمل الحفاظ على سلطتهم التنظيمية من خلال شرطين مسبقين: 1) الاستنساخ التنظيمي غير المعترف به و"غير المثير للمشاكل" للتحيّزات الاجتماعية والثقافية القائمة على الجندر و2) ممارسة تعزيز الحدود حيث يبالغ المهيمنون في القواسم المشتركة مع بعضهم البعض والاختلافات مع الرموز. هذان الشرطان يخلقان مفارقة الرؤية-الإخفاء حيث التفاوت الجندري الغير مرئي والشرعي بينما يتمّ إبراز التوقعات الجندرية وتجنيسها. نتيجة لذلك، تختبر النساء الرمزيات في الوقت نفسه بروزًا مفرطًا بسبب السمات المساعدة مثل اللباس/المظهر الجسدي، وفي الوقت نفسه، خفاءً حيث تبقى تفاعلاتهن الاجتماعية السلبية مع المسيطرين غير معترف بها. تثبت ورقتنا هذه الديناميكيات اللافتة للظهور/الاختفاء للنساء الرمزيات في أماكن العمل المندمجة في السياق المجتمعي الأبوي التقليدي للغاية في السعودية، كما هو موضح بإيجاز أدناه.
الخلفية والسياق: توظيف النساء في السعودية.
في أبريل 2016، أعلن الأمير محمد بن سلمان عن رؤية السعودية 2030، وهي خطة طموحة تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد قائم على المعرفة. ويُعد تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل أحد الأهداف الرئيسية لهذه الرؤية، حيث تسعى إلى رفع نسبة مشاركتها من 22% إلى 30% (رؤية 2030).
في هذا السياق، أطلقت الحكومة العديد من المبادرات التي تضمنت "تأنيث" بعض الوظائف والقطاعات، أي قصرها على النساء فقط، إلى جانب فرض الفصل الإلزامي في بيئات العمل بما يتوافق مع مبادئ الاحتشام الإسلامي، من خلال مطالبة أصحاب العمل بتوفير مساحات منفصلة للنساء.
كما شملت الإصلاحات إجراءات أكثر شعبية، مثل رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، وتعديل قوانين الولاية بما يتيح للمرأة العمل دون الحاجة إلى إذن من ولي أمرها الذكر، وذلك بهدف تعزيز حضورها في سوق العمل.
ورغم ذلك، وُجّهت انتقادات لهذه الإصلاحات واعتُبرت في بعض الأوساط مجرد أدوات للعلاقات العامة تفتقر إلى العمق الحقيقي. فعلى سبيل المثال، يُنظر إلى السماح للمرأة بالقيادة كخطوة رمزية لا ترافقها إصلاحات جوهرية في الحقوق السياسية والمدنية، حيث لا تزال بعض النساء اللاتي ناضلن من أجل هذا الحق قيد الاعتقال، ما يعكس توظيف الإصلاحات الشكلية لصرف الأنظار عن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.يثير عمل المرأة جدلاً واسع النطاق في السعودية.
يدعو الليبراليون إلى مشاركة غير مقيدة للمرأة في سوق العمل، بينما يروج المحافظون لحصرها في ما يُعرف بـ"الوظائف النسائية"، التي غالبًا ما تمنع التفاعل مع الذكور. وأسهمت المبادرات الحكومية في رفع عدد النساء العاملات، لا سيما في مؤسسات القطاع الخاص المختلط؛ إذ سُجلت زيادة بنسبة 152% في عدد الموظفات في هذا القطاع.
على الرغم من هذا التوسع، ما زال دور المرأة في المجتمع السعودي موضع جدل واسع. فالفئات المحافظة تسعى إلى حصر دورها في المجال المنزلي، باعتبارها رمزًا لشرف العائلة أو القبيلة، وترى في مبادرات المساواة بين الجنسين تهديدًا لوحدة الأسرة والهوية الإسلامية التقليدية. وفي المقابل، تدعم النخبة الليبرالية أجندة التحرر الاجتماعي المرتبطة برؤية 2030، وتستفيد بعض النساء على وجه الخصوص من هذه الأجواء عبر تعيينات رمزية تُقدَّم بوصفها "الأولى" من نوعها. وهناك خطاب ثالث يتعامل مع هذه الإصلاحات بتوجس، ويرى فيها أدوات سياسية لتعزيز مكانة ولي العهد أكثر من كونها توسعًا حقيقيًا في حقوق المرأة.
ولا تزال مظاهر عدم المساواة المؤسسية بين الجنسين قائمة على المستويين الثقافي والسياسي، وتنعكس على أنماط النوع الاجتماعي داخل المؤسسات، فتنتج أشكالًا خاصة بالسياق المحلي من مخططات الفرز والتخصيص والتقييم. فعلى سبيل المثال، تعمل معظم النساء السعوديات في القطاع العام المنفصل – ولا سيما في التعليم والرعاية الاجتماعية – الذي يُعَدّ "ملائمًا للنوع الاجتماعي". وإلى جانب ذلك، تقف المواقف الذكورية عائقًا أمام مسيرة المرأة المهنية، إذ تُسهم الذهنيات التقليدية لدى المشرفين الذكور في الحد من استقلاليتها المهنية وتقييد قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها الوظيفية.
تشير دراسة هينيكام وآخرون بشأن تطبيق الكوتا في مؤسسات الشرق الأوسط إلى أن هذه السياسة غالبًا ما تُستخدم كإجراء إداري شكلي، يُسهم في تعزيز القوالب النمطية والتحيزات القائمة ضد النساء بدلًا من مواجهتها. كما تظهر أدلة واضحة على استمرار الفصل الرأسي داخل سوق العمل، حيث يشغل الرجال المناصب العليا ذات المكانة والسلطة، بينما تُسند إلى النساء أدوار الدعم والمناصب الأدنى.
وبالنظر إلى منظورنا العلائقي حول الرمزية، وأهدافنا البحثية المتمثلة في استكشاف مستويات التحليل المجتمعي والتنظيمي في آن واحد، وكذلك تجليات فخاخ الأدوار في السياق الاجتماعي-المؤسسي المميز للسعودية، نسعى في هذا البحث للإجابة على سؤالين رئيسيين:
السؤال البحثي الأول (RQ1): كيف يؤثر التفاعل بين العوامل التنظيمية والمجتمعية على التجارب الحياتية للنساء الرمزية في بيئة العمل؟
السؤال البحثي الثاني (RQ2): كيف تتجلى فخاخ الأدوار الرمزية وتُختبر في سياق اجتماعي ومؤسسي خاص مثل السياق السعودي؟
يركز هذا البحث على توسيع تطبيقات نظرية الرمزية لفهم اختلال التوازن بين الجنسين في المستوى التنظيمي، من خلال تحليل التفاعل المعقد بين العوامل الفردية والتنظيمية والمجتمعية. لتحقيق ذلك، اعتمدنا على مقابلات نوعية شبه منظمة أُجريت لفهم السياقات المحلية والتجارب الشخصية بعمق، حيث تتيح هذه الأداة البحثية استكشاف مواقف المشاركين، وآرائهم، وتجاربهم الحياتية، وتسليط الضوء على كيفية تصورهم لهوياتهم وتنظيماتهم ضمن بيئاتهم الواقعية.
وقد استُكملت بيانات المقابلات (التي جمعها أحد الباحثين المشاركين) بملاحظات غير تشاركية، بالإضافة إلى مراجعة وثائق مؤسسية صادرة عن الشركات المعنية، ما أتاح تعزيز التحليل من خلال مقاربة متعددة المصادر.
دراسة حالة: الشركة السعودية
لقد اعتمدنا على شركة سعودية عالمية متعددة الجنسيات (الشركة السعودية متعددة الجنسيات)؛ وقد اختيرت لأنها (أ) منظمة مختلطة بين الجنسين على عكس القطاع العام السعودي الذي يفصل بين الجنسين، و(ب) لأنها واحدة من أكبر مؤسسات الطاقة التي تخضع لتأثيرات محلية ودولية على حد سواء. تأسست الشركة السعودية في الأصل من قبل مصالح أمريكية ولكنها أصبحت في نهاية المطاف مملوكة بالكامل للدولة السعودية. ونظرًا لسوابقها التاريخية، حافظت الشركة السعودية على أسلوب الإدارة الأمريكي (على سبيل المثال، لا تزال اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية) وتطبق قواعدها وقيمها الخاصة التي قد تختلف عن القوانين السعودية الأكثر تحفظًا. على سبيل المثال، سُمح للنساء بقيادة السيارات بحرية داخل مباني الشركة قبل إنهاء حظر القيادة رسميًا في عام 2017. ويشبه المجمّع السكني المسيّج في الشركة السعودية المُسوَّرة مدينة أمريكية يعيش فيها الموظفون مع عائلاتهم. ويتم الاحتفال بأعياد الميلاد وعيد الهالوين، ويلتحق أطفال الموظفين بالمدرسة الموجودة في الموقع والتي تدرس منهجًا أمريكيًا، والأكثر لفتًا للنظر هو الغياب الواضح للشرطة الدينية ووجود نساء غير محجبات.
وقد اكتسبت الشركة السعودية صورة إيجابية في وسائل الإعلام لدعمها تنمية المرأة وتمكينها، ودمج المرأة في الوظائف التي يهيمن عليها الذكور تقليديًا في مجالات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا، وترقية المرأة إلى مناصب قيادية في الأدوار/الأقسام الرئيسية (على سبيل المثال، تعيين أول مديرة تنفيذية وأول عالمة بترول وأول امرأة مسؤولة عن شركة تابعة في الخارج) والدعوة إلى تغييرات اجتماعية معيارية أوسع نطاقًا. ومؤخرًا، أعلنت الشركة السعودية عن هدف طموح لزيادة تمثيل المرأة إلى أكثر من 20% من قوتها العاملة (حاليًا، لا تمثل النساء سوى 8% من إجمالي القوى العاملة في الشركة البالغ عددها 76,000 امرأة). وتسعى الشركة متعددة الجنسيات إلى أن تكون "محركًا للتغيير" في المجتمع ككل؛ حيث تمول 250 مشروعًا صغيرًا تديره النساء، وتستثمر في المهارات الفنية للمرأة، وتمول برامج/مؤتمرات مكلفة للدراسة في الخارج وتخلق فرص عمل للنساء في سوق العمل الخارجي. يمكن تصنيف العديد من هذه المبادرات التنظيمية على أنها غير نمطية في السياق السعودي، حيث يتم تنفيذها بقصد محدد هو تقديم صورة تنظيمية تقدمية و"غربية".
البيانات والتحليل:
يركز هذا البحث على تجارب المشاركات واستجاباتهنّ لوضعهنّ ناقص التمثيل في الشركة السعودية. في حين أن الوصول إلى البحوث في السعودية يمثل تحديًا، لعبت خلفية المؤلفة (بصفتها امرأة سعودية) دورًا رئيسيًا في الوصول إلى المنظمة وتخفيف القلق الأولي للمشاركات في المقابلات في مناقشة تجاربهن الحياتية بشكل علني. كما انخرطت الباحثة أيضًا في مراقبة غير المشاركين لمدة شهر واحد مما أتاح العديد من الفرص للتفاعل مع المشاركين بشكل غير رسمي، ومراقبة عملهم اليومي، واكتساب نظرة أعمق في بيئة العمل والثقافة التنظيمية. تمتعت الباحثة بميزة الخلفية الثقافية والاجتماعية واللغوية المشتركة مع المشاركين، وبالتالي قبلت بصفتها باحثة من أهل البلد أثناء العمل الميداني. إن كون الباحث معترفًا به من قبل أهل البلد كواحد من المطلعين على الثقافة المحلية يولد الثقة، ويمكّن الباحث من التعامل مع المقابلات "بطريقة حساسة ومتجاوبة". ومع ذلك، فإن موقع الباحثة كمواطنة سعودية من الداخل كان مكملًا لموقعها في الغرب (أي أكاديمية تعيش وتدرس في بلد غربي منذ أكثر من عشر سنوات).
اعتمدنا نهج الاختيار غير العشوائي وتماشيًا مع تصنيف كانتر للرمزية على أنها مؤسسات تشكل فيها الإناث أقل من 15% من القوى العاملة، اخترنا شركة سعودية متعددة الجنسيات مختلطة بين الجنسين حيث تشكل النساء 8% فقط من إجمالي القوى العاملة. جمعت البيانات فقط داخل المكتب الرئيسي للشركة السعودية نظرًا لحجمه الكبير وأهميته الاستراتيجية ضمن العمليات العالمية للشركة متعددة الجنسيات. اعتمدت عملية اختيار المشاركين على أخذ عينات مقصودة وعينات كرة الثلج. تم تحديد ثلاثة من حراس البوابة من ذوي المناصب المهمة داخل الشركة السعودية من خلال العلاقات الشخصية لأحد المؤلفين بهدف الوصول إلى الشبكات التنظيمية لهؤلاء الحراس. ومن أجل زيادة حجم العينة الإجمالي، تم تعيين المشاركين في وقت لاحق من خلال توصيات من أجريت معهم المقابلات (أخذ العينات بالثلج). وشملت معايير الاختيار الرئيسية أن تكون امرأة وسعودية الجنسية ولديها أكثر من ثلاث سنوات من الخبرة العملية في الشركة السعودية. واستنادًا إلى استراتيجية أخذ العينات ومعايير الاختيار هذه، دُعيت 34 موظفة للمشاركة - ورفضت أربع موظفات المشاركة ورفضت واحدة منهن مواصلة المقابلة نظرًا لعدم ارتياحها لتسجيلها. في المجموع، تم إجراء 29 مقابلة شبه منظمة، حيث تم التقاط مجموعة متنوعة من وجهات النظر عبر مختلف الأعمار، والحالة الاجتماعية، والهياكل الأسرية، وأنواع الوظائف، وسنوات الخبرة في العمل، والمناصب والمهن الهرمية (انظر الملحق 1)
استند جدول مقابلاتنا إلى كل من الموضوعات الرئيسية التي تم تسليط الضوء عليها في عمل كانتر (1977 أ و ب) الأساسي حول الرمزية مثل توافر فرص التطور للنساء والتجارب الحية للمشاركات في العمل (من حيث الرضا الوظيفي والضغوط المرتبطة بالعمل والإحباط)؛ وكذلك أهدافنا البحثية الخاصة (مثل تأثير المعايير/القيم الاجتماعية والثقافية على العلاقات بين الجنسين في مكان العمل). علاوة على ذلك، أتاح النهج شبه المنظم المرونة لمتابعة أي مواضيع ناشئة أثناء سير المقابلة نفسها. أجريت المقابلات في مقر الشركة السعودية واستمرت عادةً لمدة 30-40 دقيقة.
اعتمد التحليل الموضوعي على بروتوكول الترميز ثلاثي المراحل لشتراوس وكوربين. تم ترميز نصوص المقابلات والوثائق التنظيمية وملاحظات الباحثة في ملاحظات الباحثة إلى أنماط أكثر تعقيدًا وترابطًا على التوالي تضيء كيف اختبر المشاركون في الدراسة الرمزية في العمل (انظر الشكل 1).
النتائج
وقد تم تنظيم النتائج التي توصلنا إليها أدناه وعرضها بما يتماشى مع أسئلتنا البحثية الرئيسية. ولذلك، نستكشف في القسم الأول من البحث في السؤال الأول من خلال تسليط الضوء على كيفية ارتباط تنفيذ السياسة التنظيمية ارتباطًا جوهريًا بالسياق المجتمعي المميز، على الرغم من السوابق الغربية للشركة السعودية. وهذا التفاعل المتناقض إلى حد ما بين العوامل التنظيمية والمجتمعية والتفسير الفردي لهذا التناقض، يخلق بدوره مواقف متناقضة (أي حالات التناقض). أما القسم الثاني فيقوم بتفكيك RQ2، مع التركيز على تصنيف كانتر (1977 أ) لتصنيف فخاخ الأدوار وتوسيع مفهوم فخ الأدوار من خلال التجارب الحية للنساء الرمزية في ظل الخلفية الاجتماعية المؤسسية المميزة للمملكة العربية السعودية.
الوقوع في مأزق: التفاعل المتناقض بين السياسة التنظيمية والمعايير المجتمعية
بشكل عام، قدمت الشركة السعودية صورة تنظيمية تقدمية و"غربية" من خلال تقديم مجموعة من مبادرات تكافؤ الفرص والعمل الإيجابي بشكل استباقي، وهو أمر غير مألوف في السياق السعودي. تم تمويل برامج الدرجات العلمية والمؤتمرات في الخارج لأن "الإدارة تحاول ... ... الإعلان عن أن الشركة لديها موظفات" (مستشارة التطوير الإداري والمهني، 29 عامًا، متزوجة، حاصلة على بكالوريوس). إن الالتزام بالصورة التنظيمية الحديثة يعني أنه في التفاعلات الخارجية (مع الشركات الأخرى أو وسائل الإعلام أو العائلة المالكة) كان من المرجح أن يتم اختيار الموظفات كمقدمات ومضيفات - لا سيما النساء اللواتي يتوافقن جسديًا مع الصورة الليبرالية "الغربية".
... عندما يكون لديهم رحلة عمل لا يرشحون الإناث اللاتي يرتدين العباءة. على الرغم من أن الشركة شركة سعودية... إلا أنهم يريدوننا أن نكون غربيات... (مساعد إداري، 38 سنة، أعزب، حاصل على دبلوم)
كانت هناك أيضًا حالات من التمييز الإيجابي حيث عُرضت على النساء في بعض الأحيان فرص عمل غير نمطية مقارنة بنظرائهن من الرجال، وهو ما يتعارض مع الأعراف الاجتماعية الراسخة بين الجنسين التي تميل إلى تفضيل الرجال,
في نفس الأسبوع الذي عادت فيه الجيولوجيات الإناث إلى الشركة بعد إنهاء دراستهن في الخارج، تلقينا توجيهات من الإدارة العليا بضرورة إرسالهن للحصول على درجة الماجستير ... على الرغم من أن النظام في الشركة هو أن أي موظف يتم إرساله للحصول على درجة الماجستير يجب أن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن 3 إلى 4 سنوات، وهؤلاء الإناث حديثات التخرج. لذا، تخيلوا أن بعض الشباب الحاصلين على معدلات تراكمية مذهلة كانوا ينتظرون لمدة 5 سنوات حتى يأتي دورهم للحصول على درجة الماجستير، واكتشفوا أن زميلاتهم (الإناث) من الخريجات الجدد يتم إرسالهن على الفور. (مستشار الإدارة والتطوير المهني، 29 عامًا، متزوج، حاصل على بكالوريوس)
ومع ذلك، لم تكن هذه السياسات التنظيمية التقدمية قائمة بذاتها، بل اصطدمت بقوة بالمعايير المجتمعية السائدة التي لا تزال تميل إلى تفضيل النمط الأبوي التقليدي. فعلى سبيل المثال، شكّلت العادات الثقافية المرتبطة بولاية الرجل – والتي تُلزم المرأة بالحصول على إذن من ولي أمرها (كالأب، أو الأخ، أو الزوج) للسفر – عائقًا أمام استفادة الموظفات من فرص التدريب والتطوير المهني غير التقليدية، لا سيما تلك التي تتطلب السفر الدولي.
كما عبّرت إحدى الموظفات عن ذلك بقولها: "لا يمكننا الخروج دون محرم... وهم (الشركة السعودية) يقولون إنهم لا يستطيعون تحمّل تكاليفي وتكاليف مرافقي... لذا، فإن إرسال رجل بدلاً عني يُعدّ خيارًا أسهل وأقل تكلفة" (رسّامة خرائط رقمية، 35 عامًا، متزوجة، حاصلة على درجة البكالوريوس).
عندما تذهب المرأة إلى مهمة يجب عليها... اصطحاب محرم... لن تكون الشركة مسؤولة عن (التكلفة المالية الإضافية...) ولكن عندما يذهب الرجل إلى نفس المهمة وإذا كان متزوجًا (مع) ثلاث أو أربع زوجات يمكنه إحضار جميع زوجاته... (مشرف، 40 سنة، متزوج، حاصل على بكالوريوس).
كان تطبيق العدسة العلائقية مفيدًا في التقاط هذا التفاعل غير المستقر وغير المرئي في كثير من الأحيان بين المعايير التنظيمية التقدمية (التي تعكس المعايير "الغربية") والتقليدية المجتمعية (المتجذرة في الأعراف الثقافية والدينية الثابتة). أبرزت التجارب الحية للمشاركات لدينا العديد من الحالات غير المعترف بها من السلوك التمييزي المتحيز وغير الداعم من الزملاء الذكور حيث طلب المديرون الذكور بشكل غير رسمي نقل موظفة من فريقهم، وتم استبعاد النساء الحوامل من المشاريع المربحة وانسحب الرجال من الاجتماعات إذا حضرت النساء.
أسفر هذا التفاعل المتناقض بين السياقات المجتمعية والتنظيمية عن حالات ازدواجية صنّفناها بوصفها مزيجًا من الحداثة/التقدمية والتقاليد الاجتماعية/التقليدية. وكان أول مأزق برز من تحليل بياناتنا ما أسميناه "سياسة الظهور والاختفاء"؛ إذ حظيت بعض الرموز بقدر متزايد من البروز نتيجة قلّتهم العددية ومظهرهم الجسدي، ولا سيما في ظل التركيز المتزايد على المظهر في السياق السعودي. والأهم أن هذا الظهور كان خاضعًا لسيطرة الفاعلين المهيمنين؛ حيث استُخدمت النساء غير المحجبات لتسويق صورة تقدمية عن المنظمة خارجيًا (مما يعكس بروزًا خارجيًا أكبر)، في حين حُرمت النساء المحجبات من فرص التدريب والتطوير والترقية (مما يعكس درجة عالية من التغييب الداخلي).
عادة ما يتم تشجيع أنواع معينة من النساء للتقدم للوظائف العليا أو للذهاب للتدريب في الخارج ... لديهم صورة معينة والسيدة التي تناسب هذه الصورة ستذهب للتدريب في الخارج ... يجب أن تكون متفتحة العقل، ذات مظهر غربي، لا ترتدي الحجاب. لديهم تصميم معين في أذهانهم، والسيدات اللاتي يناسبهن هذا التصميم سيحصلن على المزايا. (رسامة خرائط رقمية، 35 سنة، متزوجة، حاصلة على بكالوريوس)
كانت النساء الرمزيات يدركن أن هذا التلاعب المتناقض في مدى ظهورهن من قبل الزملاء الذكور مكَّنهن من تعزيز وضعهن الرمزي العددي. والأهم أن تلاعب المهيمنين بسياسات الظهور أسهم في إيجاد أو إعادة إنتاج "المجالات الأنثوية" التي عمّقت من تطبيع الاختفاء المهني والوظيفي للنساء الرمزيات. وبذلك، أسفر تفسير المهيمنين المجتمعي للمعايير التنظيمية التقدمية عن ترسيخ اختفاء النساء الرمزيات على الصعيد المهني.
الفتيات لا يقلّن كفاءةً عن الفتيان... لكن للأسف الكثير من المشرفين يعاملون الموظفات كأنهن مساعدات إداريات... بغضّ النظر عن مؤهلاتهن أو الجامعة التي تخرّجن منها. يتم تكليفهن بأعمال شكلية لا تضيف قيمة حقيقية، وهذا أمر ثقافي! (محللة نظم موارد بشرية، 51 سنة، مطلقة، حاصلة على بكالوريوس)
وتمثلت المشكلة الثانية في ردود الفعل على المستوى الجزئي للنساء الرمزيات أنفسهن حيث تعايشت ردود الفعل المتناقضة من التأييد والرفض. وافقت أقلية صغيرة من النساء اللاتي أجريت معهن المقابلات بنشاط على المعايير المجتمعية التي تدعم وضعهن الرمزي بشكل رمزي؛ وإعادة إنتاج المهيمنات لهذه المعايير المجتمعية داخل الشركة السعودية. وتجنبت هؤلاء النساء الرمزيات السياسات التنظيمية التقدمية وبدلًا من ذلك دعون إلى الفصل بين الجنسين (في الاجتماعات والمساحة المكتبية الفعلية) وتكليف النساء بأعمال الدعم/المساندة الخلفية، ورفضن السفر دون محرم (حتى إلى مواقع قريبة مثل دبي)، وتبنين الحجاب تماشيًا مع مبادئ الاحتشام الإسلامي.
ليست كل الوظائف تناسب النساء... لقد خلق الله أجسادنا بطريقة... نحن لسنا أقوياء جسديًا أو عقليًا... المهندسات لا يستطعن العمل لساعات طويلة تحت الشمس في الميدان، لكن الرجال قادرون على القيام بذلك... (قائدة مجموعة السلامة، 42 عامًا، مطلقة، حاصلة على بكالوريوس)
أعتقد أن شخصيات بعض النساء لا تصلح لأن تصبحن قائدات... النساء... ضعيفات وعاطفيات، ولسن قويات بما يكفي ليصبحن مديرات... (محللة نظم موارد بشرية، 51 سنة، مطلقة)
ومع ذلك، رفضت أخريات ممن أجريت معهن المقابلات بنشاط وضعهن الرمزي من خلال التشكيك المستمر في كل من المعايير المجتمعية والتنفيذ المتناقض للسياسات التنظيمية. وقد انتقدت بعض المديرات علنًا استمرار عدم المساواة بين الجنسين في مكان العمل ودعون إلى تغيير السياسات مع الإدارة العليا. على سبيل المثال، أبرزت إحدى المجيبات كيف كنّ يحاولن إحداث تغيير في سياسة التعيينات الدولية التي تمول معيلي الموظفين الذكور أثناء وجودهم في الخارج بينما تضطر الموظفات إلى تمويل معيليهن بأنفسهن.
... يتحدثون عن دور الإناث، لكنهم في أعماقهم ينظرون إلينا نظرة دونية... لكنني (سأواصل) القيام بورش العمل... سأقوم بالأشياء التي... تجعلني مؤهلة... تجعلني مرئية (مستشارة التدريب والتطوير المهني، 41 عامًا، حاصلة على درجة الدكتوراه).
تجارب النساء الرمزية في السعودية في التضييق على الأدوار في الشركة السعودية
أبرز تحليل البيانات التي أجريناها أن الهياكل الأبوية التقليدية السائدة خارجيًا، أعيد إنتاجها أيضًا داخل المجتمع السعودي، حيث كان يُنظر إلى الرجال على أنهم المعيلون الأساسيون/الوحيدون بينما كانت النساء يُكرّمن كأمهات وزوجات يجب إعالتهن. وقد أدت هذه المعتقدات الثقافية النمطية إلى إسناد سمات محددة للنساء الرمزية التي تشكل ما يسميه كانتر (1977) بفخاخ الأدوار. كان دور "الأم،" الذي يصف دور المرأة بوصفها الراعية والداعمة المريحة، هو الدور السائد في الشركة السعودية وتجلّى بطريقتين رئيسيتين: 1) تم تفويض النساء الرمزيات في الغالب بأدوار ثانوية وداعمة و2) تم الحفاظ على هويتهن كأمهات/زوجات/بنات خارج المؤسسة من قبل المهيمنين داخل المؤسسة وإعطائهن الأسبقية على هويتهن المهنية/العاملة.
كان الهيكل التنظيمي للشركة السعودية موزعًا بشدة على أساس الجنس، وبدا أن غالبية الموظفات يتجمعن في خدمات الدعم مع وجود عدد قليل جدًا من النساء اللاتي يشغلن مناصب في العمليات الأساسية للهندسة والجيولوجيا. تم تعيين النساء في المقام الأول كإداريات ومساعدات مكاتب ومستشارات مبتدئات بهدف تقديم الدعم للزملاء الذكور الأقدم، بغض النظر عن مؤهلاتهن أو خبراتهن العملية السابقة.
دائمًا ما تضع الإدارة النساء في أدوار تُسهّل عمل الرجال ... (نحن) نقدم خدمات تُساعد الرجال في أداء مهامهم. وتتركز النساء في وظائف منخفضة الإنتاجية... (حتى) النساء السعوديات الحاصلات على تعليم عالٍ ينتهي بهن الحال في أدوار مساندة.... (مساعدة إدارية، 38 سنة، عزباء، حاصلة على دبلوم)
تُحصر أدوار النساء في مناصب لا يُقبل عليها الرجال عادةً، على سبيل المثال، منسقة تدريب، منسقة موارد بشرية... هذه المناصب (تهيمن) عليها النساء فقط. (مستشار متدرب، 31 سنة، متزوج، حاصل على بكالوريوس)
برز فصل أفقي جنساني إضافي حيث قام المهيمنون بتكرار أدوار الدعم المجتمعي الممنوحة للنساء (كزوجات/أمهات) والحفاظ عليها من خلال تكليفهن بأعمال مكتبية. كان يُنظر إلى العمل المكتبي على أنه أكثر أمانًا وملائمًا للنساء، وبالتالي، تم استبعاد النساء الرمزيات عمدًا من العمل الميداني الأكثر ربحًا من الناحية المالية والذي يتطلب السفر وساعات عمل غير اعتيادية قد تخلق توترات في تبرئة المرأة من المسؤوليات الأسرية.
...لا يُسمح للجيولوجيات بالبقاء في الشركة بعد ساعات العمل. وتتحجج الإدارة بأن ذلك غير آمن؛ فهم يعتقدون أنه ليس من الآمن أن تدخل الموظفات إلى المبنى بمفردهن ويعملن بمفردهن مع الرجال في الليل (مستشارة إدارة وتطوير مهني، 29 سنة، متزوجة، حاصلة على بكالوريوس).
على الرغم من أن الفتيات على استعداد للعمل لوقت متأخر، وعلى استعداد للتخلي عن بعض عطلات نهاية الأسبوع، إلا أن المشرفين يرون أنه لا يمكنهم فعل ذلك معهن بسبب أنهن فتيات... وهذا يعد أمرًا ثقافيًا. (محللة نظم موارد بشرية، 51 عامًا، مطلقة، حاصلة على بكالوريوس).
علاوة على ذلك، كان يُتوقع من النساء أن يتزوجن ويتولين مسؤولية أسرهن، ولم يكن يُنظر إليهن كمعيلات أساسيات، بغض النظر عن ظروفهن أو تفضيلاتهن الفعلية. كان تطبيق المعايير المجتمعية الجنسانية من قِبَل المهيمنين يتطلب أن تقتصر توقعات النساء على "تلبية الحد الأدنى من المتطلبات في تقييمك وعدم إظهار أي مبادرة" (منسقة موارد بشرية، 46 عامًا، عزباء، حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال)، مما يؤدي إلى تجاوزهن في الترقيات، ومنحهن مهام غير مهمة عند الحمل أو مع طفل صغير، بينما "يُعطى الرجال الأولوية عندما يتعلق الأمر بالحصول على درجة أعلى أو ترقية ... (منسقة برنامج التطوير المهني، عزباء، 27 سنة، حاصلة على بكالوريوس).
"عادةً ما يقول المديرون: إن الذكور يحتاجون إلى الترقية، وإنهم (رب الأسرة)... أنت لا تعرف الكثير عني، ربما أنا أرسل المال إلى والدي، وربما أنا أيضًا (معيلة)، كيف تفترض أنني لست كذلك، لمجرد أنني أنثى؟! (مستشارة التدريب والتطوير المهني، 41 عامًا، متزوجة، حاصلة على درجة الدكتوراه).
"... تُمنح معظم الترقيات للذكور أولًا بسبب الاعتقاد الاجتماعي بأن الرجال... يتحملون مسؤوليات أكثر من النساء" (استشاري سفر، 33 عامًا، حاصل على بكالوريوس).
ومن المثير للاهتمام أن هذه التحيزات الجنسانية كانت راسخة بعمق لدرجة أنه حتى المدراء المغتربين من سياقات أكثر مساواة بين الجنسين كانوا يكررونها,
"... (مديري) الأمريكي... ليس (حتى) عربيًا... قال: إننا لن نمنحك تقييمًا جيدًا؛ لأن دخلكِ قابل للتصرف... ستبددينه على المكياج والأشياء التي لا تحتاجين إليها حقًا" (محللة نظم موارد بشرية تبلغ من العمر 51 عامًا، مطلقة وحاصلة على بكالوريوس).
برزت أيضًا في تحليل البيانات التي أجريناها في تحليلنا للبيانات مصيدة "الأليفة" التي وضعها كانتر (1977) حيث: (أ) كان يُنظر إلى موظفات الشركة السعودية على أنهن غير كفء، وذلك بناء على أساس جنسهن (بغض النظر عن مؤهلاتهن/خبراتهن الفعلية في العمل)، (ب) كان هذا الافتراض بعدم الكفاءة واضحًا ضمنيًا وصريحًا من خلال مجموعة من الممارسات التنظيمية. أبرز العديد ممن أجريت معهن المقابلات أن المديرين الذكور كان لديهم توقعات منخفضة من النساء، واعتبروهن أقل كفاءة، وبالتالي لم يعطوهن سوى فرص قليلة جدًا للتقدم والتطور.
مهما فعلنا لن يُقدِّروا ذلك... سيظنون أننا حصلنا على مساعدة في القيام بهذا العمل الشاق... لن يصدقوا أبدًا أن هذا العمل تم إنجازه بنسبة 100% من قبل امرأة (مستشارة سفر، 33 عامًا، عزباء، حاصلة على بكالوريوس)
الموقف العام هو أن المرأة غير قادرة على التفكير والعمل مثل الرجل (سكرتيرة في القسم، 31 عامًا، متزوجة، حاصلة على بكالوريوس).
كانت هذه السردية عن عدم الكفاءة بين الجنسين، ومعاملة النساء كـ "حيوانات أليفة" ذات قدرات أقل، واضحة في عدم التوافق الواضح بين مؤهلاتهن/مهاراتهن والوظائف الموكلة إليهن. تضمنت المظاهر الضمنية لفخ الدور "الأليف" مثال مديرة حاصلة على درجة الدكتوراه وخبرة 20 عامًا من العمل في الشركة السعودية التي لم يتم اختيارها أبدًا لتحل محل رئيس القسم أثناء إجازته السنوية,
رئيس قسمنا حاصل على درجة الدكتوراه مثلي، وفي كل مرة يذهب في إجازة، لم يتم استدعائي أبدًا للتغطية عنه. فهم يأتون برجل آخر من منظمة أخرى ليحل محله. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنهم يعتقدون أنني غير مؤهل (مستشار التدريب والتطوير المهني، 41 عامًا، متزوج، حاصل على درجة الدكتوراه).
وتمثلت المظاهر الواضحة لفخ دور الحيوانات الأليفة في العديد من الحالات التي كانت تعمل فيها النساء في وظائف أقل من درجة مؤهلاتهن وفي وظائف لا علاقة لها بخبراتهن. تقدم المعلومات الديموغرافية للمشاركات في هذه الدراسة (انظر الملحق رقم 1) لمحة مفيدة عن العديد من المشاركات في هذه الدراسة اللاتي أجريت معهن المقابلات وهن يحملن شهادات في مواضيع متنوعة (تتراوح بين الأعمال والهندسة وعلوم الحاسوب) ومع ذلك تم تعيينهن في وظائف إدارية/مساندة.
عندما قاموا بتوظيفي لأول مرة، أعطوني خيارًا للالتحاق إما بمكتب المساعدة أو الموارد البشرية. قررت الالتحاق بالموارد البشرية، وهو أمر لا علاقة له بتخصصي. تخصصي هو نظم المعلومات الحاسوبية (منسق موارد بشرية، 28 سنة، أعزب، ماجستير).
أنا مساعد إداري... شهادتي في المالية. أنا لست سعيدة حقًا في وظيفتي لأن هذا ليس ما أريد أن أفعله ... إنه بعيد جدًا عن تعليمي ولكن هذا ما (أُعطي لي)" (موظفة تقنية معلومات، 35 عامًا، متزوجة، حاصلة على بكالوريوس)
ومن المثير للاهتمام، لم يقدم تحليلنا أي دعم لأدوار كانتر (1977 أ) الأخرى التي حددها كانتر (1977 أ) وهي "الفاتنة" أو "العذراء الحديدية" ربما لأن النساء السعوديات يُنظر إليهن كرموز لشرف العائلة، وبالتالي لا يُتوقع منهن أن يعرضن جنسانيتهن علنًا أو يتحدين الهياكل/المعايير الأبوية. ومع ذلك، فإن هذا المأزق الخاص بالسياق الخاص بإظهار/إخفاء النساء الرمزيات قد ولّد فخًا جديدًا تمامًا من الأدوار التي أطلقنا عليها اسم "هيكاتي". هيكاتي هي إلهة إغريقية ترمز إلى مفترق الطرق (بين الماضي والحاضر والمستقبل) وتمثل الأقطاب مثل الليل والنور. وتماشيًا مع هذه المصطلحات، أبرز تحليلنا أن الموظفات السعوديات واجهن فخًا مزدوجًا يتمثل في تمثيل القيم التقدمية والتقليدية في آن واحد. وهكذا، في حين ساهم كبار المديرين الذين يغلب عليهم الذكور بشكل فعال في الحفاظ على فخ دور الأم ودور الأليفة (مع التأكيد على أدوار الرعاية وعدم التأثير والسلطة للموظفات)، فقد استخدموا أيضًا نساء رمزيات واثقات بشكل علني ولا يغطين رؤوسهن ويتبنين أسلوبًا غربيًا في اللباس لتمثيل الشركة السعودية خارجيًا. وقد أدركت المشاركات أنه تم استخدام النساء كرمز تنظيمي للتقدمية والتغريب في الفعاليات الخارجية التي شملت العائلة المالكة أو المنظمات الأجنبية المنافسة أو وسائل الإعلام الغربية.
"كلما كان لدينا حدث أو جولة من الخارج، فإن الإناث هن من يتم اختيارهن للمشاركة. هذا من أجل صورة المنظمة" (مستشارة في الإدارة والتطوير المهني، 29 سنة، متزوجة، حاصلة على بكالوريوس)
ومع ذلك، وعلى الرغم من كونهن رموزًا للتقدمية، كان لا يزال يُتوقع من النساء التمسك بالمبادئ الإسلامية التقليدية للحشمة، والتستر/الحجاب، والوداعة، والحكم ضمنيًا على العمل في مؤسسة غير منفصلة مثل الشركة السعودية.
يقول لنا الكثير من المشرفين الذكور إن على النساء البقاء في المنزل. وعادة ما يستشهدون بآيات القرآن التي تقول "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى"... يستخدم الرجال القرآن كسلاح (لتبرير) التمييز ضد المرأة (مستشارة التدريب والتطوير المهني، 41 سنة، متزوجة، حاصلة على الدكتوراه)
بعض الرجال... لا يتحدثون معك حتى... بعض الأشخاص سيخرجون إذا كنت في اجتماع معهم. إنهم لا يريدون أن يكونوا في اجتماع مختلط (مدير مشروع وقائد مجموعة الموارد البشرية، 49 عامًا، متزوج، حاصل على بكالوريوس).
والأهم من ذلك، كان يُنظر إلى فخ دور "هيكاتي" وما يرتبط به من توقعات تقليدية/مستوى تقليدي مقابل الحداثة/الثقة بالنفس، على أنه كان تحت سيطرة المهيمنين. وقد مكّن ذلك من تكرار الهيمنة الذكورية المجتمعية والحفاظ عليها داخل المنظمة، وقلّص من فاعلية الإناث وألقى بالرموز إلى الهامش.
المناقشة والاستنتاجات
وقد مكّننا تطبيق عدسة علائقية على نظرية الرمزية التي وضعها كانتر (1977 أ و ب) من دراسة التفاعل بين التأثيرات على المستوى الفردي والتنظيمي والمجتمعي؛ مما أتاح لنا تقديم العديد من الرؤى النظرية والتجريبية الفريدة. أولًا، أكدت النتائج التي توصلنا إليها على الحاجة إلى تجاوز التصور التنظيمي للرمزية على المستوى التنظيمي والنظر صراحةً في التأثير المجتمعي على المعايير التنظيمية والوكلاء التنظيميين الأفراد. ردًا على نقد هولجرسون وروماني وواتكينز وآخرون لأدبيات الرمزية الحالية لافتقارها إلى المفاهيم النظرية والتجريبية للمعايير المجتمعية والثقافية، استكشفت هذه الورقة البحثية كيف أن سياسات الشركة السعودية للتجارة والتنمية (سعوديكو) التي تبدو تقدمية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتقاليد المجتمعية. يسلط بحثنا الضوء على أن التسلسلات الهرمية بين الجنسين والهيمنة الذكورية تخضع للمعتقدات الثقافية والهياكل المجتمعية التي لا تعزز الوضع الرمزي للمرأة في المجتمع ككل فحسب، بل تؤثر أيضًا على أنماط التفاعل داخل المؤسسات وبين الأفراد. والأهم من ذلك أن هذا يعزز مستوى رمزيًا من الرمزية يتجاوز التمثيل العددي الناقص للمرأة داخل المنظمات.
ثانيًا، تسلط نتائجنا الضوء على كيفية تفاوض النساء السعوديات الرمزيات على هذا التفاعل المتناقض بين القيم والقواعد الغربية التقدمية ظاهريًا على المستوى التنظيمي والسياق المجتمعي الأبوي التقليدي. فقد عانت المشاركات في دراستنا من الظهور المتزايد (المرتبط بمظهرهن الجسدي)، وعدم المساواة في الوصول إلى الفرص الوظيفية والتمييز القائم على النوع الاجتماعي على الرغم من العمل في شركة متعددة الجنسيات التي تؤكد على المساواة بين الجنسين. يؤيد هذا الأمر الدراسات السابقة حول النتائج السلبية في مكان العمل للنساء الرمزيات مثل زيادة الظهور والعزلة وشغل عدد أقل من المناصب العليا والتعرض للحواجز الوظيفية. كما أبرز العمل المستفيض أيضًا كيف أن تجربة النساء في الظهور المتزايد على أساس النوع الاجتماعي تخلق ضغوطًا للتفوق على زملائهن الذكور. وسّعت النتائج التي توصلنا إليها سردية الظهور الجندري هذه من خلال تسليط الضوء على التواجد المشترك لـ"الظهور" المتزايد بسبب نقص التمثيل العددي والمظهر الجسدي. والأهم من ذلك، كان ذلك بالتزامن مع "الخفاء" المتزايد فيما يتعلق بالهويات المهنية والوظيفية الرمزية للنساء والوصول إلى فرص العمل. نجادل أنه من خلال اعتماد نهج علائقي لدراسة الرمزية يسلط هذا البحث الضوء على أهمية السياق المجتمعي وقيود اعتماد مفاهيم متجانسة لعمل كانتر.
ثالثًا، نقدم آثارًا نظرية مهمة للتحدي الإدراكي الثالث الذي طرحه كانتر حول الاستيعاب وتجربة النساء الرمزية في حصر الأدوار على وجه التحديد. لقد أبرز بحثنا أن الموظفات السعوديات كان يُنظر إليهن في المقام الأول إما على أنهن "أمهات" (يقدمن الدعم العاطفي للرجال داخل وخارج مكان العمل) أو "مدللات" (يشغلن أدوارًا غير مؤثرة وعديمة السلطة تتطلب مستويات أقل من المهارات والكفاءة). ومع ذلك، لم يقدم تحليلنا أي دعم لأدوار كانتر الأخرى التي حددها كانتر وهي أدوار "الفاتنة" أو "العذراء الحديدية" ربما بسبب السياق المجتمعي الفريد للسعودية. ربما خففت الإيديولوجية الدينية السائدة في الإسلام، إلى جانب المعايير الأبوية الراسخة التي يُنظر من خلالها إلى الإناث على أنهن يمثلن شرف العائلة والقبيلة من إضفاء الطابع الجنسي العلني على النساء. وبالتالي، كان التعبير العلني عن أنوثتهن مكروهًا ثقافيًا وبالتالي غير مسموح به تنظيميًا. علاوة على ذلك، فإن تصور كانتر لمفهوم "العذراء الحديدية" عن فخ دور "العذراء الحديدية" يشير إلى وكالة المرأة ومقاومتها الاستباقية، وهو أمر غير محتمل في السياق السعودي نظرًا للسيطرة السياسية القوية من قبل العائلة المالكة والحكومة، وعدم وجود تشريعات قابلة للتنفيذ بشأن تكافؤ الفرص، وغياب هياكل تمثيل الموظفين مثل النقابات العمالية.
علاوة على ذلك، برز من بياناتنا فخ دور جديد خاص بالسياق الذي صنفناه باسم "هيكاتي"، والذي يجسد الفخ المزدوج للمرأة الرمزية التي تمثل القيم التقدمية والتقليدية في آن واحد. إن غياب أدوار "الفاتنة" و"العذراء الحديدية" التي صنفها كانتر وظهور دور "هيكاتي" يؤكد كيف يمكن أن يؤدي التفاعل بين السياقات المجتمعية والتنظيمية إلى ظهور مظهر فريد من مظاهر الرمزية. وهذا يتناقض بشكل مباشر مع الاقتراحات القائلة بأن السياق الاجتماعي لا يلعب دورًا مهمًا. وتماشيًا مع نقد يودر لنظرية الرمزية، فإننا نجادل بأن حصر الأدوار في الواقع لا يمكن دراسته على المستوى التنظيمي/المهني وحده نظرًا لتأثير القوى الاجتماعية والثقافية والدينية الأوسع نطاقًا على المنظمة. نوضح في هذه الورقة البحثية كيف أن السياق التنظيمي ليس منطقة محايدة ويعيد إنتاج الخصوصيات المجتمعية فيما يتعلق بمواقف العمل السائدة (لكل من الموظفين والموظفات) وكذلك تجارب ونتائج التوظيف (من حيث الفرص الوظيفية، وديناميكيات مكان العمل، والفصل الوظيفي الأفقي والعمودي). وهذا يؤكد مرة أخرى كيف أن الرمزية تتجاوز المخاوف المتعلقة بالتمثيل العددي وتشمل أيضًا التمثيل الرمزي حيث تحتل مجموعة واحدة موقعًا مهيمنًا على الأخرى في السياق المجتمعي الأوسع، وتتكرر هذه التباينات الرمزية في ديناميكيات السلطة بدورها داخل المؤسسات. وبذلك، نسلط ضوءًا نقديًا على التنظير المحايد جندريًا داخل الرمزية. يمكن أيضًا استخدام نهجنا العلائقي الموسّع للرمزية بشكل مفيد لاستكشاف تجارب المجموعات الأخرى (على سبيل المثال، الأقليات الجنسية أو العرقية أو الإثنية أو الدينية) التي تعاني من نقص التمثيل العددي في المنظمة وتحتل وضعًا من الحرمان التاريخي والهيكلي في المجتمع.
في الختام، فإن تركيزنا على التفاعل بين السياقات التنظيمية والمجتمعية له أيضًا أهمية بالنسبة لمساحات واسعة من الجنوب العالمي التي تتميز اجتماعيًا ومؤسسيًا مقارنة بالسياقات الغربية في الغالب التي تمت دراستها في أدبيات الرمزية الموجودة. وفي حين دعا يودر وواتكينز وآخرون الباحثين في مجال النوع الاجتماعي إلى النظر في السياقات الاجتماعية المختلفة عند وضع مفهوم الرمزية، فإن دراستنا هي المحاولة التجريبية الأولى التي تقدم منظورًا علائقيًا للسياق المجتمعي فيما يتعلق بالرمزية. لقد ركز الباحثون في السابق على علامات أضيق للسياق الجنساني على سبيل المثال، العرق في مهن العمل غير التقليدية ولكن لا يوجد بحث حتى الآن يبحث في الرمزية في مقابل السياق المجتمعي. لذلك، يوسع هذا البحث الحالي من التصورات الحالية للسياقات الجنسانية ويقدم تقييمًا أوسع نطاقًا لتصورات المساواة بين الجنسين.
المراجع:
Acker J (2006) Inequality regimes: Gender, class, and race in organizations. Gender & Society 20(4): 441-464.
Al-Rasheed M (2018) Modern Woman in the Kingdom of Saudi Arabia- Rights, Challenges, and Achievements. Journal of Middle East Women's Studies 14 (3): 351–353.
Arab News (2019) Saudi Arabia ends restrictions on women traveling: Royal Decree. Arab News, August 01. Available at: https://www.arabnews.com/node/1534241/saudi-arabia
Ashraf J, Ayaz M, and Hopper T (2019) Precariousness, gender, resistance and consent in the face of global production network’s ‘Reforms’ of Pakistan’s garment manufacturing industry. Work, Employment and Society 33 (6): 895-912
Bishop R (2008) Freeing ourselves from neocolonial domination in research: A Kaupapa Ma ̃ori approach to creating knowledge. In: Denzin N, & Lincoln Y (3rd eds.) The Landscape of Qualitative Research. Thousand Oaks, CA: Sage, 145–183
Catalyst (2018) Women in management: global comparison. Catalyst, 31 October. Available at: https://www.catalyst.org/research/women-in-the-workforce-global/
Chambliss E, Uggen C (2000) Men and women of elite law firms: reevaluating Kanter’s legacy. Law and Social Inquiry25: 41–68.
Denzin NK, Lincoln YS (2017). The Sage handbook of qualitative research. Sage publications.
Elamin AM, Omair K (2010) Males' attitudes towards working females in Saudi Arabia. Personnel Review 39(6):746-766.
Ehteshami A (2018) Saudi Arabia as a resurgent regional power. The International Spectator 53(4):75-94.
Eum I (2019) New Women for a New Saudi Arabia? Gendered Analysis of Saudi Vision 2030 and Women’s Reform Policies. Asian Women 35(3): 115-133.
Gardiner M, Tiggemann M (1999) Gender differences in leadership style, job stress and mental health in male‐and female‐dominated industries. Journal of Occupational and Organizational Psychology 72(3): 301-315.
General Authority for statistics Kingdom of Saudi Arabia. (2018) Labour Market, Fourth Quarter 2018. Available at: https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/lm_2018_q4_en.pdf
Gupta N (2015) Rethinking the relationship between gender and technology: A study of the Indian example. Work, employment and society 29(4):661-672.
Haas M, Koeszegi ST, and Zedlacher E (2016) Breaking patterns? How female scientists negotiate their token role in their life stories. Gender, Work & Organization 23(4):397-413.
He G, Wu X (2018) Dynamics of the Gender Earnings Inequality in Reform-Era Urban China. Work. Employment and Society 32(4):726-746.
Hennekam S, Tahssain‐Gay L, and Syed J (2017) Contextualising diversity management in the Middle East and North Africa: A relational perspective. Human Resource Management Journal 27(3):459-476.
Holgersson C, Romani L (2020) Tokenism Revisited: When Organizational Culture Challenges Masculine Norms, the Experience of Token Is Transformed. European Management Review DOI: 10.1111/emre.12385
Kanter RM (1977a) Men and women of the corporation. New York: Basic Books, Inc.
Kanter RM (1977b) Some effects of proportions on group life: Skewed sex ratios and responses to token women. American Journal of Sociology 82: 965-990.
King EB, Hebl MR, George JM, and Matusik SF (2010) Understanding tokenism: Antecedents and consequences of a psychological climate of gender inequity. Journal of Management 36(2), 482-510.
Lyness K, Thompson D (2000) Climbing the corporate ladder: do female and male executives follow the same route. Journal of Applied Psychology 85: 86–101.
Moshashai D, Leber AM, and Savage JD (2018) Saudi Arabia plans for its economic future: Vision 2030, the National Transformation Plan and Saudi fiscal reform. British Journal of Middle Eastern Studies 1-21.
Naseem S, Dhruva K (2017) Issues and Challenges of Saudi Female Labor Force and the Role of Vision 2030. International Journal of Economics and Financial Issues 7(4): 23-27.
Patton MQ (2002) Qualitative evaluation and research methods (3rd edition). Newbury Park, CA: Sage Publications.
Powell A, Bagilhole BM, and Dainty ARJ (2009) How women engineers do and undo gender: consequences for gender equality. Gender, Work and Organization 16(4):411–28.
Ridgeway, C., (1991). The social construction of status value: Gender and other nominal characteristics. Social forces, 70 (2), 367–386.
Simpson R, Lewis P (2005) An investigation of silence and a scrutiny of transparency: re-examining gender in organization literature through the concepts of voice and visibility. Human Relations 58:1253–1275.
Simpson R (2000) Gender mix and organisational fit: how gender imbalance at different levels of the organisation impacts on women managers. Women in Management Review 15(1), 5-18.
Simpson R (1997) Have times changed? Career barriers and the token woman manager. British Journal of Management8:121–129.
Stake, RE (1995) The Art of Case Study Research. London: SAGE.
Strauss A, Corbin J (1990) Basics of qualitative research. Sage publications: London.
Syed J, Ali F, and Hennekam S (2018) Gender equality in employment in Saudi Arabia: a relational perspective. Career Development International 23(2): 163-177.
Tatli A, Ozturk MB, and Woo HS (2017) Individualization and marketization of responsibility for gender equality: The case of female managers in China. Human Resource Management 56(3): 407-430.
Torchia M, Calabrò A, and Huse M (2011) Women directors on corporate boards: From tokenism to critical mass. Journal of Business Ethics 102(2): 299-317.
Vision 2030 (2019) Vision2030govsa. Available at: https://vision2030.gov.sa/en
Watkins MB, Simmons A, and Umphress E (2018) It’s not black and white: Toward a contingency perspective on the consequences of being a token. Academy of Management Perspectives 33(3): 334–365.
Whittock M (2002) Women’s experiences of non-traditional employment: is gender equality in this area possible? Constructing Management and Economics 20(5): 449–56
Wingfield, A. H. (2009). Racializing the glass escalator: Reconsidering men's experiences with women's work. Gender & Society, 23(1), 5-26.
Yin, RK (2013) Case Study Research: Design and Methods. SAGE. Beverly Hills, CA.
Yoder JD (2002) 2001 Division 35 presidential address: Context matters: Understanding tokenism processes and their impact on women’s work. Psychology of Women Quarterly 26: 1-8.
Yoder J, Berendsen L (2001) Outsider within the firehouse: African American and White women firefighters. Psychology of Women Quarterly 25:27−36.
Young JL, James E (2001) Token majority: The work attitudes of male flight attendants. Sex Roles 45: 299-320.
Zahra SA (2011) Doing research in the (new) Middle East: Sailing with the wind. Academy of Management Perspectives 25(4):6-21.